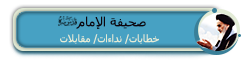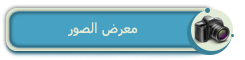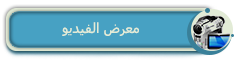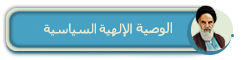إنّ حضور القلب يعني اهتمامه وتوجّهه إلى العالم المعنويّ. وإنّ العالم المعنويّ الذي يمثّل حياة القلوب يتجلّى بالمعارف الإلهيّة. فإذا وصل القلب مع هذه الحقائق إلى درجة اليقين والشهود، يصبح صاحبه من أهل تلك العوالم وسكّانها.لهذا كان التوجّه إلى الحقّائق هو بداية السّير نحو العوالم الغيبية.
يقول الإمام الخمينيّ قدس سره: "من الآداب القلبيّة المهمّة الذي يمكن أن يكون كثير من الآداب مقدّمة له، والعبادة بدونه ليس لها روح، وهو بنفسه مفتاح قفل الكمالات وباب أبواب السّعادات، وقلّما ذُكر في الأحاديث الشّريفة شيء بهذه المثابة، وقلّما اهتُمّ بشيء من الآداب كهذا الأدب، حضور القلب".
أهمّيّة حضور القلب
يغفل البعض عن أهمّيّة حضور القلب في العبادات عندما يتصوّر أنّ تحصيله صعب وثقيل. ولأنّهم لم يعرفوا معنى العبادة وحقيقتها، ظنّوا أنّ مجرّد أداء بعض الحركات والتلفّظ ببعض الكلمات يمكن أن يعطي نتيجته المرجوّة، ولهذا يقوم الإمام الخمينيّ قدس سره بتشريح تفصيليّ لمعنى العبادة من خلال الإشارة إلى نتائجها والتي تحصل وفق المراحل الآتية:
1- توحيد سلطة النفس:
"كما ذكرنا سابقًا، بأنّ العبادات والمناسك والأذكار والأوراد إنّما تنتج نتيجة كاملة إذا صارت صورة باطنيّة للقلب، وتخمّر باطن ذات الإنسان بها، وتصوّر قلب الإنسان بصورة العبوديّة، وخرج عن الهوى والعصيان. وذكرنا أيضًا أنّ من أسرار العبادات وفوائدها أن تتقوّى إرادة النفس وتتغلّب النفس على الطبيعة، وتكون القوى الطبيعية مسخّرة تحت قدرة النفس وسلطنتها، وتكون إرادة النفس الملكوتيّة نافذة في ملك البدن، بحيث تكون القوى بالنسبة إلى النفس كملائكة الله بالنسبة إلى الحقّ تعالى ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾3، ﴿وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾.
2- خضوع إرادة النفس لإرادة الله:
"ونقول الآن: إنّ من أسرار العبادات وفوائدها المهمّة التي تكون بقيّة الفوائد مقدّمة لها، أن تكون مملكة البدن بجميعها، ظاهرها وباطنها، مسخّرة تحت إرادة الله، ومتحرّكة بتحريك الله تعالى، وتكون القوى الملكوتيّة والملكيّة للنفس من جنود الله، وتكون كلّها كملائكة الله.
وهذه من المراتب النازلة لفناء القوى والإرادات في إرادة الحقّ".
3- تبدّل الهويّة إلى الربّانيّة:
"ويترتّب على هذا بالتدريج النتائج العظيمة، ويصبح الإنسان الطبيعيّ إلهيًّا، وتكون النفس مرتاضة بعبادة الله، وتنهزم جنود إبليس بشكل نهائيّ وتنقرض، ويكون القلب مع قواه مسلّماً للحقّ، ويبرز الإسلام ببعض مراتبه الباطنيّة في القلب، وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحقّ في الآخرة أنّ الحقّ تعالى ينفّذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبيّة، ويجعله مثلًا أعلى لنفسه. فكما أنّه تعالى وتقدّس يُوجد كلّ ما أراد بمجرّد الإرادة، يجعل إرادة هذا العبد أيضًا كذلك، كما روى بعض أهل المعرفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف أهل الجنّة أنّه يأتيهم ملك فيستأذن للدخول عليهم، وبعد الاستئذان يدخل فيبلّغ السلام من الله تعالى عليهم، ويعطي كلّاً منهم رسالة مكتوباً فيها: من الحيّ القيّوم الذي لا يموت إلى الحيّ القيّوم الذي لا يموت، أمّا بعد، فإنّي أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "فلا يقول أحد من أهل الجنّة للشيء كن، إلّا ويكون" وبعد ذكر هذه النتائج والثمار وما يحصل في رحلة السالك العباديّة يبيّن الإمام قدس سره أنّ كلّ ذلك موقوف على أمرٍ واحد، وهو حضور القلب، فيقول قدس سره: "وهذه هي السلطنة الإلهيّة التي تعطى للعبد لأجل تركه إرادة نفسه وترك سلطنة الأهواء النفسانيّة وإطاعة ابليس وجنوده، ولا تحصل كلٌّ من هذه النتائج المذكورة إلّا بالحضور الكامل للقلب".
آثار غفلة القلب
في مقابل حضور القلب هناك الغفلة والسّهو عن العبادة وعن أسرارها ومعانيها. فما الذي يمكن أن يحصل في حال أهمل العابد قضية تحصيل حضور القلب، يجيب الإمام الخمينيّ قدس سره قائلًا: "وإذا كان القلب في وقت العبادة غافلًا وساهيًا، لا تكون عبادته حقيقيّة، بل تشبه اللهو واللعب، ولا يكون لمثل هذه العبادة أثر في النفس البتّة، ولا تتجاوز العبادة من الصورة والظاهر إلى الباطن والملكوت، كما أشير إلى ذلك في الأحاديث، ولا تكون القوى النفسانيّة بمثل تلك العبادة مسلمة للنفس، ولا تظهر سلطنة النفس لها، كذلك القوى الظاهريّة والباطنيّة لا تكون مستسلمة لإرادة الله، ولا تنقهر المملكة تحت كبرياء الحقّ كما هو واضح جدًّا.
ولذا، ترون أنّه بعد مضيّ أربعين أو خمسين سنة لا يحصل أثرٌ في أنفسنا، بل تزداد يومًا فيومًا ظلمة القلب، ويزيد اشتياقنا إلى الطّبيعة وإطاعتنا للأهواء النفسانيّة والوساوس الشيطانيّة آناً فآناً. وليس هذا كلّه إلّا من جهة أنّ عبادتنا قشور بلا لبّ، وفاقدة للشرائط الباطنيّة والآداب القلبيّة. هذا، في حين أنّنا نرى كتاب الله سبحانه قد نصّ على أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا النهي ليس صوريّا البتّة، بل لا بدّ من مصباح يزهر في القلب، ويضيء نور في الباطن يهدي الإنسان إلى عالم الغيب، ويوجِد زاجرًا إلهيًّا ينهى الإنسان عن العصيان والتمرّد.
وها نحن أولاء نحسب أنفسنا في زمرة المصلّين، وقد مضت علينا سنون ونحن مشتغلون بهذه العبادة العظيمة، ومع ذلك لا نرى في أنفسنا هذا النور، ولا نجد في باطننا هذا الزاجر والمانع...".
أحاديث في الترغيب في حضور القلب
لا شكّ أنّ الإنسان يحتاج إلى وجود دافع قويّ في نفسه من أجل السعي على طريق تحصيل حضور القلب، لما ذكرنا من أنّه أمر صعب وثقيل لمن كان قلبه غافلًا رَدَحًا من الزمن، وقضى عمره بعيدًا عن هذه التوجّهات. وهنا تأتي الأحاديث الشريفة لترغيبنا وحثّنا على الاهتمام بحياتنا المعنويّة. وقد ذكر الإمام بعض هذه الأحاديث، فقال قدس سره: "في ذكر باقة من أحاديث أهل البيت العصمة والطهارة عليهم السلام في الترغيب في حضور القلب، ونحن نكتفي هنا بذكر بعضها: فعن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: "اعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك".
يستفاد من هذا الحديث مرتبتان من مراتب حضور القلب:
الأولى: أنّ السالك يكون مشاهدًا جمال الجميل، ومستغرقًا في تجلّيات حضرة المحبوب على نحو تكون جميع مسامع قلبه مسدودة عن سائر الموجودات، وتكون بصيرته مفتوحة على جمال ذي الجلال الطاهر ولا يشاهد غيره. وبالجملة، يكون مشغولًا بالحاضر وغافلًا عن المحضر والحضور.
وإلى هذا أشير في الحديث الذي رواه أبو حمزة الثمالي (رضي الله عنه)، قال: "رأيت عليّ بن الحسين عليه السلام يصلّي، فسقط رداؤه عن منكبه، فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك، فقال: "ويحك، أتدري بين يديّ من كنت؟!".
والثانية: التي هي دون تلك المرتبة، أن يرى السالك نفسه حاضرًا في محضره، ويلاحظ أدب الحضور والمحضر.
فكأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كنت تستطيع أن تكون من أهل المقام الأوّل، وتأتي بعبادة الله على ذلك النحو فافعل، وإلّا فلا تغفل عن أنّك في المحضر الربوبيّ. ولمحضر الحقّ تعالى أدب، تكون الغفلة عنه لا محالة بعدًا عن مقام العبوديّة.
في حديثٍ أيضاً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ الرجلين من أمّتي يقومان في الصلاة، وركوعهما وسجودهما واحد، وإنّ ما بين صلاتهما ما بين السماء والأرض".
وقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله وجهه حمارا".
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "من صلّى ركعتين، ولم يحدّث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ذنوبه".
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى العشر، وإنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها، وإنّما ليس لك من صلاتك إلّا ما أقبلت عليه بقلبك".
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا قام العبد المؤمن في صلاته، نظر الله إليه، أو قال أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلّته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفّه من حوله إلى أفق السماء، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه، يقول له: أيّها المصلّي، لو تعلم من ينظر إليك، ومن تناجي ما التفتّ، ولا زلت من موضعك أبدًا".
وقال الإمام الصادق عليه السلام: "لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلّا وجبت له الجنّة. فإذا صلّيت فأقبل بقلبك إلى الله عزّ وجلّ، فإنّه ليس من عبد يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلّا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين، وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة".
وعن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنّهما قالا: "ما لك من صلاتك إلّا ما أقبلت عليه فيها، فإن أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لفّت، فضرب بها وجه صاحبها".
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: "إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع منها له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة".
وعن الإمام الصادق عليه السلام "إِذَا أَحْرَمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَأَقْبِلْ عَلَيْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَقْبَلْتَ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْكَ، وَإِذَا أَعْرَضْتَ أَعْرَضَ اللهُ عَنْكَ، فَرُبَّمَا لَمْ يُرْفَعْ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوِ السُّدُسُ عَلَى قَدْرِ إِقْبَالِ الْمُصَلِّي عَلَى صَلَاتِهِ، وَلَا يُعْطِي اللهُ الْغَافِلَ شَيْئا".
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في تفكّر، خير من قيام ليلة والقلب ساه (لاه)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا المقدار كافٍ لأرباب القلوب اليقظة وأصحاب الاعتبار".
عوامل ضعف حضور القلب
1- الانخداع بالتسويف:
يقول الإمام الخمينيّ قدس سره: "وبالجملة، أيها القارئ، المحترم، الذي تطالع هذه الأوراق، لا تكن ككاتبها خاليًا من جميع الأنوار وصفر اليد من جميع الأعمال الصالحة، ومبتلىً بالأهواء النفسانيّة... وارحم نفسك واكتسب من عمرك نتيجة، وانظر بعين الدّقّة في حال الأنبياء والأولياء الكمّل، وارمِ الرغبات الكاذبة والوعود الشيطانيّة وراء ظهرك، ولا تغترّ بغرور الشيطان، ولا تنخدع بخدع النفس الأمّارة، فإنّ تدليسات الشيطان والنفس دقيقة للغاية، وإنّهما ليعميان على الإنسان كلّ أمر باطل فيراه بصورة الحقّ، ويخدعانه أحياناً بصورة الأمل بالتوبة في آخر العمر حتى ينتهي أمر الإنسان إلى الشقاوة، مع أنّ التوبة في آخر العمر، وعند تراكم ظلمات المعاصي، وكثرة مظالم العباد، وكثرة حقوق الله، أمر صعب للغاية.
ففي هذا اليوم تكون إرادة الإنسان قويّة والقوى الشبابيّة على حالها وشجرة العصيان لم تشتدّ بعد، وسلطنة الشيطان في النفس لم تستحكم، والنفس جديدة العهد بالملكوت وقريبة الأفق إلى فطرة الله، وشرائط حصول التوبة وقبولها سهلة، فهما لا يدعان الإنسان يقدم على التوبة ويقتلع هذه الشجرة الواهنة من جذورها، ويقضي على هذه السلطنة غير المستقلّة، ويعدانه بالتوبة في أيام الشيب التي تكون الإرادة فيها ضعيفة والقوى هزيلة والأشجار المختلفة للمعاصي ذات جذور عميقة وقويّة وسلطنة إبليس في الظاهر والباطن مستقلّة ومستقرّة، وألفة الإنسان للطبيعة شديدة، والبعد عن الملكوت أزيد ونور الفطرة خافتاً ومنطفئًا، وشرائط التوبة صعبة ومرّة. وليس هذا إلا الغرور والافتتان".
2- الانخداع بالشفاعة:
"وحيناً آخر يبعدان الإنسان بوعد شفاعة الشافعين عليهم السلام عن ساحة قدسهم، ويجعلانه من شفاعتهم محرومًا. فإنّ الانغماس في المعاصي يجعل القلب بالتدريج مظلمًا ومنكوسًا، ويجرّ أمر الإنسان إلى سوء العاقبة. وإنّما طمع الشيطان في أن يسرق إيمان الإنسان، وهو يجعل التوغّل في المعاصي مقدّمة لذلك، حتى يصل إلى غايته. فهذا الإنسان، إن كان طمعه في شفاعة الشافعين، فلا بدّ له أن يسعى ويجتهد في هذا العالم للحفاظ على الرابطة بينه وبين الشافعين، وأن يتفكّر في حال شفعاء يوم الحشر، كيف كان حالهم في العبادة والرياضة. ولو فرضنا أنّكم ترتحلون من هذه الدنيا مع الإيمان بالله، ولكن مع أثقال من الذنوب والمظالم كثيرة فيمكن ألا يُشفع فيكم في أنواع الذنوب عند البرزخ والقبر، كما نقل عن الصادق عليه السلام من أنّ "البرزخ على عهدتكم"24. وعذاب البرزخ لا يقاس بعذاب هذه الدنيا، وطول مدّة البرزخ لا يعلمه إلا الله، ولعلّه يمتدّ لملايين السنين.
ومن الممكن أن ننال تلك الشفاعة يوم القيامة، ولكن بعد فترات مديدة وأنواع العذاب التي لا تطاق، كما ورد مثل هذا المعنى في الأحاديث أيضاً. فهذا الغرور من الشيطان يمنع الإنسان من العمل الصالح، ويخرجه من الدنيا، إمّا بلا إيمان أو مع أثقال ذنوب كثيرة، ويبتليه بالشقاوة والخسران".
3- الانخداع بالرحمة الواسعة:
"وربما يعد الشيطان الإنسان بالرحمة الواسعة لأرحم الراحمين، وبنفس هذا الوعد يقطع الشيطانُ يد الإنسان عن ذيل الرحمة. وهذا الإنسان غافل عن أنّ بعث الرسل وإرسال الكتب وإنزال الملائكة والوحي والإلهام على الأنبياء والهداية إلى طريق الحقَّ كلّ ذلك من شؤون رحمة أرحم الراحمين، وقد اتّسعت الرحمة الواسعة لجميع العالم، ونحن على شفا عين الحياة نهلك من الظمأ.
هذا القرآن هو أكبر رحمة إلهيّة. فإن كنت تطمع في رحمة أرحم الراحمين وتأمل رحمته الواسعة فاستفد من هذه الرحمة. فإنّه قد فتح طريق الوصول إلى السعادة وبيّن طريق الهداية من الضلالة، وأنت تلقي بنفسك في بئر الهلاك وتنحرف عن الطريق المستقيمة، فأين النقصان في الرحمة؟!
ولو كان من الممكن أن يُري الله الإنسان طريق الخير والسعادة بطريقة أخرى لكان سبحانه أراه إيّاه بمقتضى سعة رحمته. ولو كان من الممكن أن يوصل الإنسان إلى السعادة إكراهاً لكان الأنبياء يوصلونه. لكن هيهات، إنّ طريق الآخرة لا يمكن أن يُسعى فيها إلّا بقَدم الاختيار، وإنّ السعادة لا تحصل بالجبر، وإنّ الفضيلة والعمل الصالح بلا اختيار ليسا فضيلة ولا عملًا صالحًا، ولعلّ هذا معنى الآية الشريفة ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. نعم، ما يمكن أن يُعمل فيه الإكراه والإجبار هو صورة الدين الإلهيّ لا حقيقته، وإنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا مأمورين أن يفرضوا على الناس صورة الدين ما استطاعوا وبأيّ نحو ممكن، حتّى تصبح صورة العالم صورة العدل الإلهيّ.
ولكنّهم بالنسبة إلى الباطن ليس لهم إلا مجرّد الإرشاد، حتّى يمشي الناس في هذه الطريق بأنفسهم وينالوا السعادة باختيارهم. وبالجملة، فإنّ هذا الوعد بالرحمة الواسعة لأرحم الراحمين هو أيضاً من غرور الشيطان ليقطع يد الإنسان عن الرحمة بطمع الرحمة"
المصدر:كتاب الآداب المعنوية للصلاة.