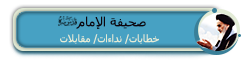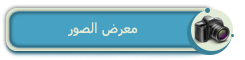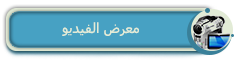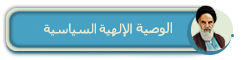أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله وأنّ علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم خلفاؤه وأنّ ما جاء به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حق، وأنّ القبر والنشور والجنّة والنار حق وأن الله يبعث من في القبور
وصية من أبٍ عجوز أهدر عمره ولم يتزوّد للحياة الأبدية ولم يخطُ خطوةً خالصةً لله المنان، ولم ينجُ من الأهواء النفسانية والوساوس الشيطانية، لكنه غير آيسٍ من فضل وكرم الكريم تعالى وهو يأمل بعطف وعفو الباري جلّ وعلا، ولا زاد له سوى هذا.. إلى إبنٍ يتمتّع بنعمة الشباب متاحة أمامه فرصة لتهذيب النفس وللقيام بخدمة خلق الله، والأمل أن يرضى عنه الله تعالى، كما رضي عنه أبوه، وان يوُفّقَ ما بوسعه خدمةً للمحرومين، الشريحة الأكثر استحقاقاً لتقديم الخدمة إليها من بين جماهير الشعب الأخرى، والتي أوصى بها الإسلام.
بُنيّ أحمد ـ رزقك الله هدايته:
اعلم، أنّ العالم سواء كان أزلياً وأبدياً أم لا، وسواء كانت سلاسل الموجودات غير متناهية أم لا، فإنّها جميعاً محتاجة، لأنّ وجودها ليس ذاتياً لها، ولو تفكّرت وأحطت عقلياً بجميع السلاسل غير المتناهية فإنك ستدرك الفقر الذاتي والاحتياج في وجودها وكمالها إلى الوجود الموجود بذاته والذي تمثل كمالاته عين ذاته، ولو تمكنت من مخاطبة سلاسل الموجودات المحتاجة بذاتها خطاباً عقلياً وسألتها: أيتّها الموجودات الفقيرة، من يستطيع تأمين احتياجاتك؟
فإنها ستردُّ جميعاً بلسان الفطرة: "إننا محتاجون إلى ما ليس محتاجاً بوجوده مثلنا إلى الوجود، والذي هو كمال الوجود". وهذه الفطرة أيضاً ليست من ذاتها، ففطرة التوحيد {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} من الله، والمخلوقات الفقيرة بذاتها لن تتبدل إلى غنيّة بذاتها، فمثل هذا التبدّل غير ممكن الوقوع، ولأنها فقيرة بذاتها ومحتاجة، فلن يستطيع سوى الغنيّ بذاته من رفع فقرها واحتياجها، كما ان هذا الفقر، الذي يمثل أمراً لازماً ذاتياً فيها، هو صفة دائمة أيضاً، سواء كانت هذه السلسلة أبدية أم لا، أزلية أم لا، وليس سواه تعالى من يستطيع حلَّ مشاكلها وتأمين احتياجاتها، كذلك فإن أيّ كمال أو جمال ينطوي عليه أيّ موجود ليس منه ذاتاً، انما هو مظهر لكمال الله تعالى وجماله فـ{وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} حقيقة تصدق على كل أمر وكل فعل، وكلّ من يدرك هذه الحقيقة ويتذوقها، فلن يُعلّق قلبه بغير الله تعالى، ولن يرجو غيره تعالى.
هذه بارقة إلهية، حاول ان تفكّر فيها في خلواتك، وان تلقّن قلبك الرقيق وتكرّر عليه هذه الحقيقة إلى ان ينصاع اللسان لها، وتسطع هذه الحقيقة في ملك وملكوت وجودك. وارتبط بالغنيّ المطلق حتى تستغني عمّن سواه، واطلب التوفيق منه حتى يجذبك من نفسك ومن جميع من سواه، ويأذن لك بالدخول والتشرّف بالحضور في ساحته المقدسة.
ولدي العزيز:
ان الله جلّ وعلا {هو الأول والآخر والظاهر والباطن} كما "أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل مدلّ عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟! عميت عين لا تراك عليها رقيباً".
متى كنت غائباً فأتمنّى لُقياك ومتى كنت مستوراً عن النظر لأبحث عنك
فهو ظاهر، وكل ظهورٍ هو ظهور له سبحانه وتعالى، ونحن بذاتنا حجب فأنانيتنا وأنيّتنا هي التي تحجبنا "أنت حجاب نفسك، فانطلق منه يا حافظ".
فلْنلذ به ولنطلب منه تبارك وتعالى متضرعين مبتهلين ان ينجينا من الحجب "إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقةً بعزّ قدسك. إلهي واجعلني ممّن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك".
بني:
نحن مازلنا رهن الحجب الظلمانية، وبعدها الحجب النورية، ومازلنا في منعطف زقاق ضيّق.
بني:
إسعَ أن لا تُنكر المقامات الروحانية والعرفانية، مادمت لست من أهل المقامات
المعنوية، فإن من أخطر مكائد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ـ التي تصدُّ الانسان
عن بلوغ جميع المدارج الانسانية والمقامات الروحانية ـ هي دفع الإنسان إلى انكار
السلوك إلى الله والاستهزاء به أحياناً، ممّا يجرُّ إلى الخصومة والضدّية لهذا
الأمر. وبذا فإنه سيموت أثر جميع الأنبياء العظام (صلوت الله عليهم) والأولياء
الكرام (سلام الله عليهم) والكتب السماوية خصوصاً القرآن الكريم ـ كتاب بناء
الإنسان الخالد ـ والتي جاءت لتحقيق هذا الأمر، سيموت قبل أن يولد.
فالقرآن الكريم ـ كتاب معرفة الله ومعرفة طريق السلوك إليه تعالى ـ تحوّل بأيدي
الجاهلين من محبّيه إلى سبب جرّهم للانحراف والانزواء، فجعلوا يصدرون عنه الآراء
المنحرفة، ويفسّرونه بالرأي ـ الأمر الذي نهى عنه جميع أئمة الإسلام(عليه السلام) ـ
وراح كل واحد منهم يتصرف فيه بما تُمليه نفسانيته.
لقد نزل هذا الكتاب العظيم في بلدٍ وفي محيطٍ كان يمثّل أشدّ حالة من حالات الوقوع
في الظلمة، كما نزل بين قوم يمثّلون أشدّ الناس تخلّفاً في ذلك العصر، وقد أُنزل
على شخص وعلى قلب إلهيٍّ لشخص كان يعيش في ذلك المحيط. كذلك فإن القرآن الكريم
اشتمل على حقائق ومعارف لم تكن معروفة آنذاك في العالم أجمع فضلاً عن المحيط الذي
نزل فيه، وإن من أعظم وأسمى معاجزه هي هذه المسائل العرفانية العظيمة التي لم تكن
معروفة لدى فلاسفة اليونان، فقد عجزت كتب ارسطو وافلاطون ـ أعظم فلاسفة ذلك العصر ـ
عن بلوغ معانيها، بل الأشدّ من ذلك أنّ فلاسفة الاسلام الذين ترعرعوا في مهد القرآن
الكريم، وانتهلوا منه ما انتهلوا من مختلف المعارف لجأوا إلى تأويل بعض الآيات التي
صرّحت بحياة الموجودات في العالم، والحال أن عرفاء الإسلام العظماء إنما أخذوا ما
قالوه منه، فكل شيءٍ أخذوه من الاسلام ومن القرآن الكريم. فالمسائل العرفانية
الموجودة في القرآن الكريم ليست موجودة في أيّ كتاب آخر. وإنها لمعجزة الرسول
الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ كان على درجةٍ عالية من المعرفة بالله تعالى
بحيث ان الباري جلّ وعلا يوضح له اسرار الوجود، وكان هو(صلى الله عليه وآله وسلم)
بدوره يرى الحقائق بوضوح ودون أي حجاب، وذلك بعروجه وارتقائه قمة كمال الإنسانية،
وفي ذات الوقت كان حاضراً في جميع أبعاد الإنسانية ومراحل الوجود، فمثّل بذلك أسمى
مظهر {هو الاول والآخر والظاهر والباطن} كما سعى إلى رفع جميع الناس للوصول إلى تلك
المرتبة، وكان يتحمّل الآلام والمعاناة حينما كان يراهم عاجزين عن بلوغ ذلك، ولعل
قوله تعالى {طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} إشارة خفيّة إلى هذا المعنى، ولعل
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): "ما أوذي نبيّ مثلما أوذيت" يرتبط أيضاً بذات
المعنى.
إنّ أولئك الذين بلغوا هذا المقام أو ما يماثله، لا يختارون العزلة عن الخلق أو
الانزواء، فهم مأمورون بإرشاد وهداية الضالّين إلى هذه التجلّيات ـ وان كانوا لم
يُوفّقوا كثيراً في ذلك ـ أمّا اولئك الذين بلغوا مرتبة ما من بعض هذه المقامات،
وغابوا عن انفسهم بارتشاف جرعة ما، وظلوا بذلك في مقام الصّعق، فانهم وان كانوا قد
حازوا مرتبة ومقاماً عظيماً، إلا أنهم لم يبلغوا الكمال المطلوب. فقد سقط موسى
الكليم(عليه السلام) بحال الصعق نتيجة تجلّي الحق، وأفاق بعناية إلهية خاصة، ثم أمر
بتحمل أمر ما، وكذا فإن خاتم النبيين، الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، أمر
ـ بعد بلوغه القمة من مرتبة الإنسانية وما لا تبلغه العقول من مظهرية الاسم الجامع
الأعظم ـ بهداية الناس بعد أن خاطبه تعالى {يا أيّها المدثر، قم فأنذر}.
ولدي العزيز:
هدفت مما ذكرته لك ـ رغم اني لا شيء، بل أقلّ حتى من اللاشيء ـ لأن ألفت نظرك إلى
أنّك إن لم تبلغ مقاماً ما، فعليك أن لا تنكر المقامات المعنوية والمعارف الإلهية،
ولكي تصبح من أولئك الذين يحبّون الصالحين والعارفين، وإن لم يكونوا منهم. وحتى لا
تغادر هذه الدنيا وأنت تكنّ بعض العداء لأحباب الله تعالى.
بني:
تعرّف القرآن ـ كتاب المعرفة العظيم ـ ولو بمجرد قراءته، واجعل منه طريقاً إلى
المحبوب، ولا تتوهمن ان القراءة من غير معرفة لا أثر لها، فهذه وساوس الشيطان، فهذا
الكتاب كتاب من المحبوب إليك وإلى الجميع ـ وكتاب المحبوب محبوب، وان كان العاشق
المحب لا يدرك معنى ما كتب فيه ـ وقد جاء إليك هادفاً إلى خلق هذا الأمر لديك "حب
المحبوب" الذي يمثل غاية المرام، فلعله يأخذ بيدك.
واعلم أننا لو أنفقنا أعمارنا بتمامها في سجدة شكر واحدة على أن القرآن كتابنا؛ لما
وفّينا هذه النعمة حقها من الشكر.
بنيّ:
إن الأدعية والمناجات التي وصلتنا عن الأئمة المعصومين(عليه السلام) أعظم دليل يرشد
إلى معرفة الله جلّ وعلا، وأسمى وسيلة لسلوك طريق العبودية، وأرفع رابطة بين الحق
والخلق. كما أنها تشتمل في طيّاتها على مختلف المعارف الإلهية، وتمثّل أيضاً وسيلة
ابتكرها أهل بيت الوحي للأنس بالله جلت عظمته، فضلاً عن أنها تمثل نموذجاً لحال
أصحاب القلوب وأرباب السلوك. فلا تصدنّك وساوس الغافلين الجاهلين عن التمسّك أو
الأنس بها. إننا لو أمضينا أعمارنا بتماهها نقدم الشكر على أنّ هؤلاء ـ المتحررين
من قيود الدنيا والواصلين إلى الحق ـ هم أئمتنا ومرشدونا؛ لما وفينا هذا الأمر حقه
من الشكر.
بنيّ:
من الأمور التي أودّ أن أوصيك بها ـ وأنا على شفا الموت، أصعّد الانفاس الأخيرة ـ:
أن تحرص ـ مادمت متمتعاً بنعمة الشباب ـ على دقة اختيار من تعاشرهم وتصاحبهم، فليكن
انتخابك للأصحاب من بين أولئك المتحررين من قيود المادة، والمتديّنين المهتمّين
بالأمور المعنوية، ممن لا تغرهم زخارف الدنيا ولا يتعلقون بها، ولا يسعون إلى جمع
المال وتحقيق الآمال في هذه الدنيا أكثر مما يلزم، أو أكثر من حدّ الكفاية، ومن لا
تلوّث الذنوب مجالسهم ومحافلهم، ومن ذوي الخلق الكريم. اسعَ في ذلك، فإن تأثير
المعاشرة على الطرفين من إصلاح وإفساد أمر لاشك في وقوعه. اسعَ ان تتجنب المجالس
التي توقع الانسان في الغفلة عن الله، فإن ارتياد مثل هذه المجالس قد يؤدّي إلى سلب
الانسان التوفيق، الأمر الذي يعدّ ـ بحدّ ذاته ـ خسارة لا يمكن جبرانها.
اعلم أن في الانسان ـ ان لم نقل في كل موجود ـ حباً فطرياً للكمال المطلق وللوصول
إلى الكمال المطلق، وهذا الحب مما يستحيل أن يفارق الإنسان تماماً، كما ان الكمال
المطلق محال ان يتكرر أو أن يكون اثنين؛ فالكمال المطلق هو الحق جلّ وعلا، والجميع
يبحثون عنه، وإليه تهفو قلوبهم ولا يعلمون، فهم محجوبون بحجب الظلمة والنور. لذا
فهم يتوهّمون أنهم يطلبون شيئاً آخر غيره، ولذا تراهم لا يقنعون بتحقيق أيّة مرتبة
من الكمال، ولا بالحصول على أيّ جمال أو قدرة أو مكانة. فهم يشعرون أنهم لا يجدون
في كل ذلك ضالّتهم المنشودة؛ فالمقتدرون ومن يمتلكون القدرة الكبرى، هم في سعي دائم
للحصول على القدرة الأعلى مهما بلغوا من القدرة، وطلاب العلم يطلبون الدرجة الأعلى
من العلم مهما بلغوا منه، وهم يشعرون دوماً انهم لم يجدو ضالّتهم، وفي الحقيقة أنهم
غافلون عنها.
ولو أعطي الساعون إلى القدرة والسلطة، التصرف في جميع العالم المادي من الأرضين
والمنظومات الشمسية والمجرات، بل وكل ما هو فوقها، ثم قيل لهم: إن هناك قدرةً فوق
هذه القدرة التي تملكونها، أو أن هناك عالماً أو عوالم أخرى فوق هذا العالم، فهل
تريدون الوصول إليها؟ فإنهم من المحال أن لا يتمنون ذلك، بل انهم من المحتم أن
يقولوا بلسان الفطرة: ليتنا بلغنا ذلك أيضاً!. وهكذا طالب العلم، فهو إن ظنّ ان
هناك مرتبة أخرى ـ غير ما بلغه ـ فإنّ فطرته الباحثة عن المطلق ستقول: ياليت لي هذه
القدرة، أو ياليت لي سعةً من العلم تشمل تلك المرتبة أيضاً!
وعليه فإن ما يُطمئن النفس المنفلتة، ويهدّئ من لهيبها، ويحدُّ من إلحاحها
واستزادتها في الطلب، إنما هو الوصول إليه تعالى، والذكر الحقيقي له جلّ وعلا؛ لأن
الاستغراق في ذلك فقط، هو الذي يبعث الطمأنينة والهدوء، وكأنّ قوله تعالى {ألا بذكر
الله تطمئن القلوب} هو نوع من الاعلان أن: انتبه! انتبه! عليك أن تلجأ إلى ذكره حتى
تحصل على الطمأنينة لقلبك الحيران الذي يواصل القفز من جانب إلى جانب، والطيران من
غصنٍ إلى غصن.
إذن فما دام الله سيبعث في قلبك الطمأنينة بذكره، فاستمع يا ولدي العزيز لنصحية أب
عانى من الحيرة والقلق، ولا تتعب نفسك بالانتقال من باب إلى باب، للوصول إلى هذا
المنصب أو تلك الشهرة أو ما تشتهيه النفس، فأنت مهما بلغت من مقام، فإنك سوف تتألم
وتشتد حسرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك، وإن سألتني: لِمَ لم تعمل أنت بهذه
النصيحة؟! أجبتك بالقول: انظر إلى ما قال، لا إلى من قال… فما قلته لك صحيح، حتى
وإن صدر عن مجنون أو مفتون؛ يقول تعالى في محكم كتابه العزيز {ما أصاب من مصيبة في
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير}، ثم يتبع
ذلك بقوله {لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال
فخور}. فالإنسان في هذا العالم معرّض لأمورٍ شتى، فهو عرضة أحياناً لأن تنزل به
المصائب، كما أنه قد يلاقي إقبالاً من الدنيا، فيبلغ فيها المقام والجاه ويحصل على
المال ويحقّق آمانيه وينال القدرة والنعمة، وكلا الحالين ليس بثابتٍ؛ فلا ينبغي أن
تُحزنك المصائب والحرمان فتفقدك صبرك، لأنها قد تكون أحياناً في نفعك وصلاحك {وعسى
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم}، كما لا ينبغي أن تدفعك الدنيا بإقبالها عليك
وتحقيقها ما يُشبع شهواتك إلى أن تتكبر وتختال على عباد الله، فما أكثر ما تعدّه
أنت خيراً، وهو شر لك.
بنيّ:
إن السبب الرئيس للندم، وأساس ومنشأ جميع ألوان الشقاء والعذاب والمهالك، ورأس جميع
الخطايا والذنوب إنما هو "حب الدنيا" الناشئ من "حب النفس"، بيد أنه ينبغي القول أن
عالم الملك ليس مبغوضاً ولا مذموماً في حدّ ذاته، فهو تجلّي الحق ومقام ربوبيته
تعالى، ومهبط ملائكته، ومسجد ومحلّ تربية الأنبياء والأولياء(عليه السلام)، ومحراب
عبادة الصلحاء، وموطن تجلّي الحق على قلوب عاشقي المحبوب الحقيقي؛ فإن كان حب "عالم
الملك" والتعلق به ناشئ عن حب الله ـ باعتباره محلاً لتجليات الحق جلّ وعلا ـ فهو
أمر محثوث عليه ويستوجب الكمال، أما إذا كان منشؤه حب النفس، فهو رأس الخطايا
جميعاً. إذن فالدينا المذمومة هي في داخلك أنت، والتعلق بغير صاحب القلب وحبه، هو
الموجب للسقوط. وفي الوقت نفسه فإن أيّ قلبٍ لا يمكنه ـ فطريّاً ـ أن يتعلق بغير
صاحب القلب الحقيقي، وجميع المخالفات لأوامر الله وجميع المعاصي والجرائم والجنايات
التي يبتلى بها الانسان، كلها من "حب النفس" الذي يولّد "حب الدنيا" وزخارفها، وحب
المقام والجاه والمال ومختلف الأماني هي التي تجعلنا نميل خطأً واشتباهاً نحو غير
صاحب القلب، وهي ظلمات فوقها ظلمات.
نحن وأمثالنا لم نصل الحجب النورانية بعدُ، ومازلنا أسرى الحجب الظلمانية! فمن قال:
"هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنِرْ أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار
القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة" فقد اخترق الحجب الظلمانية وتعدّاها. أمّا
الشيطان الذي خالف أمر الله ولم يسجد لآدم، فقد رأى نفسه عظيماً، لأنه كان في الحجب
الظلمانية و{ … أنا خير منه خلقتني من نار …} جعلته يُطرد ويُبعد عن ساحة الربوبية!
نحن أيضاً مازلنا في حجاب النفس والأنانية، فنحن شيطانيّون مطرودون من محضر الرحمن،
وما أصعب تحطيم هذا الصنم الذي يعدّ "أمّ الأصنام"! فنحن مادمنا خاضعين له مطيعين
لأوامره، فنحن غير خاضعين لله جلّ وعلا، غير طائعين لأوامره؛ وما لم يُحطّم هذا
الصنم؛ فإن الحجب الظلمانية لن تتمزق ولن تُزال. لكي يتحقق ذلك، علينا أن نعرف
ماهية الحجاب أولاً، فنحن إذا لم نعرفه، لن نستطيع المبادرة إلى إزالته، أو تضعيف
أثره ـ أو في الأقل ـ الحدّ من تزايد رسوخه وقوته بمرور الوقت.
روي أنّ بعض الاصحاب كانوا يجالسون الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) فسُمع صوت
مهيب، فسألوا: ما هذا الصوت؟ فقال(صلى الله عليه وآله وسلم) "انه صوت حجر كان قد
ألقي إلى جهنم قبل سبعين سنة، وقد بلغ قعرها الآن". بعدها علموا أنّ كافراً كان قد
مات حينها عن سبعين سنة من العمر. وإذا صح الحديث فإن من سمعوا الصوت لابد أنهم
كانوا من أهل الحال، أو قد يكون الأمر قد تمّ بقدرة الرسول الأكرم(صلى الله عليه
وآله وسلم) قاصداً إسماع الغافلين وتنبيه الجاهلين.
أما إذا لم يصح الحديث ـ ولا أذكره بالنص ـ فإن الأمر في حقيقته كذلك، فنحن نسير
عمراً بكامله باتجاه جهنم، فنحن نمضي العمر بتمامه نؤدي الصلاة التي تعدّ أكبر موطن
لذكر الله المتعال ـ ونحن معرضون عن الحق تعالى، وعن بيته العتيق، متوجهين إلى
الذات وإلى بيت النفس. وما أشدّ الألم في ذلك! فالصلاة التي ينبغي أن تكون معراجاً
لنا، وتدفعنا نحوه تعالى، وتكون جنّة لقائه تعالى، نؤديّها ونحن متوجهون إلى النفس،
وإلى منفى جهنم.
بنيّ:
لم أقصد من هذه الإشارات إيجاد السبيل لأمثالي وأمثالك لمعرفة الله وعبادته حق
العبادة ـ مع أنه قد أُثر عن أعرف الموجودات بالحق تعالى، وأعرفها بحق العبادة له
جلّ وعلا، قوله: "ما عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك" ـ وإنما لأجل أن نفهم
عجزنا، وندرك ضآلتنا، ونهيل التراب على فرق أنانيتنا، لعلّنا بذلك نكبح جماح هذا
الغول، ولعلنا نلجمه بعد ذلك ونروّضه، فنتحرر بعدها من خطر عظيم يكوي ـ مجرد تذكره
ـ الروح ويحرقها.
وعليك أن تنتبه! فهناك خطر قد يتعرض له الإنسان في اللحظات الأخيرة من عمره، وهو
يهمّ بمغادرة هذا العالم، والانتقال إلى مستقره الأبديّ، فإن ذلك قد يجعل المبتلى
بحب النفس وما يولّده من حب الدنيا ـ بأبعادهما المختلفة ـ يرى وهو في حال الاحتضار
ـ وحيث تنكشف للإنسان بعض الأمور فيراها عياناً ـ أن "مأمور الله" جلّ وعلا سبب في
فصله عن محبوبه ومعشوقه! فيرحل عن هذه الدنيا وهو غاضب على الله جلّ وعلا متنفر
منه! وهذه عاقبة ونتيجة حب النفس والدنيا. وقد أشارت إلى ذلك الروايات المختلفة.
ينقل أحد المتعبدين الثقاة فيقول: "ذهبت لزيارة أحدهم ـ وكان يحتضر ـ فقال وهو على
فراش الموت: إن الظلم الذي لحقني من الله تعالى لم يلحق أحداً من العالمين، فهو
يريد أن يأخذني من أطفالي الذين صرفت دم القلب في تربيتهم ورعايتهم! فقمت من عنده
ثم أسلم روحه إلى بارئها". لعل هناك بعض التفاوت بين ما نقلته وما سمعته من ذلك
العالم المتعبد.
على أيّة حال، فإن صحّ ذلك فهو أمر على درجة خطيرة من الأهمية تدفع الإنسان إلى
التفكير بجدّية في أمر خاتمته وعاقبته!
إننا لو فكرنا ساعة في أمر موجودات العالم ـ التي نمثل نحن جزءاً منها ـ وأدركنا أن
أيّ موجود ليس لديه شيء من نفسه، وان ما وصله وما وصل إلى الجميع إنما هي ألطاف
إلهية ومواهب عارية، وأن الألطاف التي مَنّ الله تعالى بها علينا ـ سواء قبل أن
نأتي إلى الدنيا، أو خلال حياتنا فيها، ومنذ الطفولة إلى آخر العمر، أو بعد الموت ـ
بواسطة الهداة الذين كُلّفوا بهدايتنا، فلعل بارقة من حبه جلّ وعلا ستلوح في أفق
وجودنا، الأمر الذي حُجبنا عنه، فندرك بعدها مدى ضآلتنا وتفاهتنا، فيفتح بذلك لنا
طريق نحوه جلّ وعلا، وننجو في الأقل من "الكفر الجهوري" وإنكار المعارف الإلهية،
ونمتنع عن عدّ المظاهر الرحمانية مقامات لنا، والمفاخرة بها، الأمر الذي سيبقينا
أسرى الوقوع في بئر "ويل" الأنانية والغرور إلى الأبد.
يُروى أن "الله تعالى خاطب أحد أنبيائه، فطلب إليه أن يأتيه بمخلوق أدنى منه، فقام
النبي(عليه السلام) بعد ذلك بسحب رفاة حمار يقصد عرضها على أنها مخلوق أدنى منه،
إلا أنه نَدم فتركها، فلما وصل وحده إلى لقاء الله خاطبه عزّ وجلّ بالقول: لو أنك
أتيتني بتلك الرفاة، لكنت سقطت عن مقام النبوة"! وإني لا أعلم مدى صحة الحديث، ولكن
لعلّ الأمر بالنسبة لمقام الأولياء، يعد سقوطاً حينما يرون الأفضلية لأنفسهم على
غيرهم، فتلك أنانية وغرور، وإلا فلِمَ كان النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)
يأسف ذلك الأسف المرير على المشركين ومن لم يؤمنوا، إلى الحدّ الذي جعل الله تعالى
يخاطبه بالقول {فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً}؟!
فهذا ليس سوى أنه عشق جميع عباد الله، فالعشق لله عشق لتجلّياته ومظاهر عظمته.
فهو(صلى الله عليه وآله وسلم) يتألم ممّا تؤدي إليه حجب الأنانية والغرور الظلمانية
في المنحرفين من دفعهم إلى الشقاء ثم العذاب الأليم في جهنم ـ النتيجة الطبيعية
لأعمالهم ـ، في حين أنه يريد السعادة للجميع، فهو مبعوث لتحقيق السعادة للجميع،
والمشركون المنحرفون ـ عُمي القلوب ـ وقفوا بوجهه، ونصبوا له العداء رغم أنه جاء
لإنقاذهم!
أنا وأنت إذا وفّقنا إلى إيجاد بصيصٍ من هذا العشق لتجليات الحق ـ الذي يميّز
أولياء الله في أنفسنا ـ وأحببنا الخير للجميع، فقد بلغنا مرتبةً من الكمال
المطلوب.
اللهم أفِض على قلوبنا الميّتة من فيض رحمتك، ومن فيض الرحمة المصطفاة الذي بعثته
رحمة للعالمين.
أهل المعرفة يعلمون بأن الشدة على الكفار ـ وهي من صفات المؤمنين ـ وقتالهم أيضاً
رحمة، ولطف من الألطاف الخفية للحق؛ فالعذاب ـ الذي هو من أنفسهم ـ يزداد على
الكفار مع كل لحظة تمرّ عليهم، زيادة كمية وكيفية إلى ما لا نهاية له. لذا فإن
قتلهم ـ مع اليأس من صلاحهم ـ رحمة في صورة غضب، ونعمة في صورة نقمة، علاوة على
الرحمة التي ستنال المجتمع بقتلهم، فهم عضو كان يمكن أن يجرّ المجتمع كله إلى
الفساد، والقضاء عليهم يشبه إلى حدّ كبير قطع العضو المعطوب من البدن مخافة أن يؤدي
عدم قطعه بالبدن كله إلى التلف والهلاك. وهذا هو الذي جعل نوحاً يدعو الله { … ربِّ
لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً * إنك أن تذرهم يُضلّوا عبادك ولا يلدوا إلاّ
فاجراً كفّاراً}، وهو أيضاً المراد بقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}. وعلى
هذا وعلى ما سبقه، كانت الحدود والتعزيرات والقصاص رحمة من أرحم الراحمين بمرتكب
الجرم أولاً، وبالمجتمع بأسره ثانياً.
ولنتخطَّ هذه المرحلة.
بنيّ:
إذا استطعت ـ بالتفكر والتلقين ـ فاجعل نظرتك إلى جميع الموجودات ـ وخصوصاً البشر ـ
نظرة رحمة ومحبة. وإلاّ أليست الموجوات كافة ـ والتي لا حصر لها ـ واقعة تحت رحمة
خالق العالمين من جهات عديدة؟! ثم أليس وجودها وحياتها وجميع بركاتها وآثارها من
رحمات الله ومواهبه على الموجودات؟! وقيل: "كل موجود مرحوم". وإلا فهل يمكن لموجود
ممكن الوجود أن يكون له شيء من نفسه؟! أو أن يستطيع موجود (ممكن الوجود) مثله أن
يعطيه شيئاً ما؟! لذا فإن الرحمة الرحمانية هي الشاملة للعالم بأسره. ثم أليس الله
هو ربّ العالمين ـ وتربيته تشمل العالم؟ أوليست تربيته مظهراً للرحمة؟! وهل يمكن أن
تكون الرحمة والتربية شاملة للعالم دون اقترانها بالعناية والألطاف الإلهية؟! إذن
لِمَ لا يكون من شملته العنايات والألطاف والمحبة الإلهية موضعاً لمحبتنا؟! وإذا لم
يكن هذا الأمر منّا، أليس هو نقص فينا؟! أليس هو ضيق أفق وقصر نظر من قبلنا؟!.
انتبه يا ولدي! فقد بلغتُ أنا الشيخوخة دون ان أتمكن من علاج هذه النقيصة، أو سواها
من النقائص التي لا تحصى، وأنت مازلت شاباً، ولاشك أنّك أقرب إلى رحمة الله
وملكوته، فاسعَ في علاج هذه النقيصة. وفّقك الله ووفقنا والجميع لاختراق هذا
الحجاب، والتحلّي بما تقتضيه فطرة الله.
تعرضت فيما سبق إلى جانب من هذا الأمر، ودعني الآن أشير بوضوح إلى ما يساعدك في
اختراق هذا الحجاب:
نحن مفطورون على العشق للكمال المطلق، ومن هذا العشق ـ شئنا أم أبينا ـ ينشأ العشق
لمطلق الكمال الذي يمثل آثار الكمال المطلق، والأمر الملازم لفطرتنا هذه هو السعي
للخلاص من النقص المطلق، مما يستلزم أن تنطوي أنفسنا على الرغبة في الخلاص من مطلق
النقص أيضاً.
إذن، نحن ـ رغم عدم علمنا وعدم فهمنا ـ عاشقون لله تعالى، لأنه الكمال المطلق. وبذا
فنحن نعشق آثاره التي هي تجلّيات الكمال المطلق، وأيّ شخص أو أيّ شيء نكرهه ونبغضه،
أو نحاول التخلص منه، فهو: لا كمال مطلق ولا مطلق الكمال، بل: نقص مطلق أو مطلق
النقص ـ الأمر الذي يقف في الجهة المقابلة، وعلى النقيض من الأول تماماً ـ. ولاشك
أن نيقض الكمال هو عدم الكمال، ولأننا محجوبون، فإننا نضلّ في التشخيص، ولو زال
الحجاب لاتّضح لنا أن كلّ ما هو منه جلّ وعلا محبوب، وكل ما هو مبغوض من قبلنا فهو
ليس منه تعالى؛ وهو بالتالي ليس موجوداً.
واعلم ان هناك تساهلاً في التعبيرات الواردة فيما يخصّ المتقابلات، والموضوع أعلاه
ـ رغم موافقته للبرهان المتين وللآراء العرفانية والمعرفة ورغم ما ورد في القرآن
الكريم من إشارات إليه ـ إلا أن التصديق والإيمان به في غاية الصعوبة، ومنكريه في
غاية الكثرة، والمؤمنين به قلة نادرة؛ فحتى أولئك الذين يعتقدون بثبوت هذه الحقيقة
عن طريق البرهان لا يؤمن بها منهم إلا قلة قليلة! فالإيمان بأمثال هذه الحقائق لا
يحرز إلا بالمجاهدة والتفكر والتلقين.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الإدّعاء (بأن بعض الأمور البرهانية يمكن أن لا تكون
موضعاً للتصديق والإيمان) عقدة يصعب الاقتناع بها، بل لعل البعض قد يقطع بأنه أمر
لا أساس له. ولكن ينبغي أن تعلم بأن هذا الأمر أمر وجداني، وقد وردت أشارات إليه في
القرآن الكريم، كالآيات الكريمة من سورة التكاثر.
ولإثباته عن طريق الوجدان، نورد المثال التالي: أنت تعلم بأن الموتى لا تصدر عنهم
أية حركة، وأنهم لا يستطيعون إلحاق الأذى بك، وأن الموتى لا يعادلون ذبابةً حية
واحدة من حيث الأثر والفعالية، كما تدرك أنهم لا يمكن أن يعودوا إلى الحياة في هذا
العالم بعد موتهم وقبل يوم النشور، إلا أنك قد لا تمتلك القدرة على النوم وحيداً
براحة في المقابر. هذا ليس إلاّ لأن قلبك لم يصدق بما عندك من علم، وأن الإيمان
بهذا الأمر لم يتحصّل لديك، في حين أنّ أولئك الذين يقومون بتغسيل وتكفين الموتى
تحصّل لهم الإيمان واليقين بهذا الأمر نتيجة تكرار العمل، فهم يستطيعون الخلوة مع
الموتى براحة بال واطمئنان. كذلك فإن الفلاسفة الذين أثبتوا بالبراهين العقلية أن
الله حاضر في كل مكان، دون أن يصل قلوبهم ما أثبتته عقولهم بالبرهان، ولم تؤمن به
قلوبهم، فإن أدب الحضور لن يتحقق لديهم، في حين أن أولئك الذين أيقنوا بحضور الله
بقلوبهم، وآمنت قلوبهم بذلك، فإنهم ـ رغم أن لا علاقة لهم بالبراهين ـ فإنّهم
يتحلّون بأدب الحضور، ويجتنبون كلّ ما ينافي حضور المولى. فالعلوم المتعارفة إذن ـ
وإن كانت علوم فلسفة وتوحيد ـ لكنها تعدّ في حد ذاتها حجباً، وهي تزيد الحجاب غلظة
وسمكاً كلّما زادت؛ فإننا نعلم جميعاً ونرى أن دعوة الأنبياء(عليه السلام)
والأولياء الخلص لله لا تتّخذ الفلسفة والبرهان المتعارف لسان حالٍ لها، بل انهم
يهتمون بأرواح وقلوب الناس، ويسعون إلى يصال نتائج البراهين إلى قلوب العباد، وبذل
الجهد لهدايتهم من داخل الروح والقلب.
وإن شئت فقل: ان الفلاسفة وأهل البراهين يزيدون الحجب، في حين أن الأنبياء(عليه
السلام) وأصحاب القلوب يسعون إلى رفعها، لذا ترى أن من تربّوا على أيدي الأنبياء
مؤمنون وعاشقون، في حين أن طلاب علماء الفلسفة أصحاب برهانٍ وقيل وقال، لا شأن لهم
بالقلب والروح.
وليس معنى ما أوردته أن تتجنب الفلسفة والعلوم البرهانية والعقلية، أو أن تشيح
بوجهك عن العلوم الاستدلالية، فهذا خيانة للعقل والاستدلال والفلسفة، فأنا أقصد
القول: بأن الفلسفة والاستدلال وسيلة للوصول إلى الهدف الأصلي، فلا ينبغي ـ والحال
كذلك ـ أن تحجبك عن المقصد والمقصود والمحبوب.
أو فقل: إن العلوم معبر نحو الهدف وليست الهدف بحد ذاتها، فكما أن الدنيا مزرعة
الآخرة، فإن العلوم المتعارفة مزرعة للوصول إلى المقصود، تماماً كما أن العبادات
معبر نحو الله جلّ وعلا، فالصلاة ـ وهي أسمى العبادات ـ معراج المؤمن. وجميع هذه
الأمور منه وإليه تعالى.
وإن شئت فقل: ان المعروف بجميع أنواعه درجات في سلّم الوصول إلى الله تعالى، وجميع
المنكرات موانع في طريق الوصول، والعالم بأسره يبحث عنه تعالى، ويحوم كالفراش
باحثاً عن جماله الجميل. وياليتنا نصحو من نومتنا ونلج أول منزل وهو اليقظة! ولعله
جلّ وعلا يأخذ بأيدينا ـ بألطافه وعناياته الخفيّة ـ فيرشدنا إلى جماله الجميل،
وياليت أن هذه الفرس الجموح تهدأ قليلاً، فتنزل عن مقام الإنكار، وليت أننا نلقي
بهذا العبء الثقيل من على كواهلنا إلى الأرض، فننطلق مخفّين نحوه تعالى! وليت إننا
نحترق كالفراش حول شمع جماله دون أن نتكلم! وياليتنا نخطو خطوة واحدة بقدم الفطرة
ولا نبتعد عن طريقها بهذا القدر، و…، و…، وآلاف التمنيات والأمنيات الأخرى التي
تزدحم في ذاكرتي، وأنا على شفير الموت في شيخوختي هذه، ولكن دون أن تصل يدي إلى
مكان ما!.
وأنت يا بنيّ:
استفد من شبابك، وعد بذكره ومحبته جلّ وعلا إلى العيش وتمضية العمر بالفطرة، فذكر
المحبوب لا يتنافى مع الفعالية السياسة والاجتماعية، أو السعي إلى خدمة شريعته
وعباده جلّ وعلا، بل إنه سيعينك ـ وأنت تسلك الطريق إليه ـ، ولكن لتعلم بأن خدع
النفس الأمارة بالسوء وشيطان النفس والمحيط كثيرة، فما أكثر ما يبتعد الإنسان عن
الله باسم الله واسم الخدمة لخلق الله، ويساق نحو نفسه وآمالها! لذا كانت مراقبة
النفس ومحاسبتها في تشخيص طريق الأنانية عن طريق الله من جملة منازل السالكين،
وفّقنا الله وإيّاكم لبلوغ ذلك.
وما أكثر ما يخدعنا شيطان النفس ـ نحن الشيوخ وأنتم الشبّان ـ بوسائل مختلفة، فهو
دائم الجري وراءنا ـ نحن الشيوخ ـ يواجهنا بسلام اليأس من الحضور وذكر الحاضر
فينادي: لقد فاتكم العمر، وتصرّم وقت الإصلاح ومضت أيّام الشباب التي كان ممكناً
فيها الإستعداد والاصلاح، ولا قدر لكم في أيام ضعف الشيخوخة هذه على الإصلاح، فقد
استحكمت جذور شجرة الأهواء والمعاصي في جميع أركان وجودكم وتشعّبت فروعها، فأبعدتكم
عن اللياقة بمحضره جلّ وعلا، وضاع كلّ شيء! فما أحرى ان تستفيدوا من هذه الأيام
الباقية من أعماركم أقصى ما يمكن من الاستفادة، وهكذا.
وقد يتصرف معنا احياناً بنفس الطريقة التي يتصرف بها معكم أيها الشبان، فهو يقول
لكم: أنتم شبان، ووقت الشباب هذا هو وقت التمتع والحصول على اللذات، فاسعوا الآن
بما يساهم في إشباع شهواتكم، ثم توبوا إن شاء الله في أواخر أعماركم، فإن باب رحمة
الله مفتوحة والله أرحم الراحمين؛ وكلما زادت ذنوبكم، فإن الندم والرغبة في الرجوع
إلى الحق سيزداد، وسيكون التوجه إلى الله تعالى أكبر والإتصال به جلّ وعلا أشدّ،
فما أكثر أولئك الذين تمتعوا في شبابهم، ثم أمضوا آخر أيامهم بالعبادة والذكر
والدعاء وزيارة مراقد الإئمة(عليه السلام) والتوسل بشفاعتهم، فرحلوا عن هذه الدنيا
وهم سعداء! تماماً هكذا يتصرف معنا نحن الشيوخ، فيأتينا بأمثال هذه الوساوس فيقول
لنا: ليس معلوماً أن تموتوا بهذه السرعة، فالفرصة مازالت موجودة فلْتؤجّلوا التوبة
إلى آخر العمر، فضلاً عن ان باب شفاعة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته
مفتوح، وإن أمير المؤمنين(عليه السلام) لن يتخلى عن محبيه ويتركهم يتعذبون، فسوف
ترونه عند الموت، وسوف يأخذ بأيديكم. وأمثال هذه الوساوس الكثيرة التي يلقي بها في
سمع الإنسان.
بنيّ:
أتحدث إليك الآن لأنك مازلت شابّاً، عليك أن تنتبه إلى أن التوبة أسهل على الشبان،
كما أن اصلاح النفس وتربيتها يتم بسرعة أكبر لدى الشبان، في حين أن الأهواء
النفسانية والسعي للجاه وحب المال والغرور أكثر وأشدّ بكثير لدى الشيوخ منه لدى
الشبان. أرواح الشبان رقيقة شفافة سلسلة القياد، وليس لدى الشبان من حب النفس وحب
الدنيا بقدر ما لدى الشيوخ؛ فالشاب يستطيع بسهولة ـ نسبيّاً ـ أن يتخلص من شر النفس
الأمارة بالسوء، ويتوجّه نحو المعنويات. وفي جلسات الوعظ والتربية الأخلاقية يتأثر
الشبان بدرجة كبيرة لا تحصل لدى الشيوخ. فلينتبه الشبان، وليحذروا من الوقوع تحت
تأثير الوساوس النفسانية والشيطانية، فالموت قريب من الشبان والشيوخ على حدّ سواء،
وأيّ من الشبان يستطيع الاطمئنان إلى أنه سيبلغ مرحلة الشيخوخة؟! وأي إنسان مصون من
حوادث الدهر؟! بل قد يكون الشبان أكثر تعرضاً لحوادث الدهر من غيرهم.
بنيّ:
لا تضيع الفرصة من يديك، واسع لإصلاح نفسك في مرحلة الشباب.
على الشيوخ أيضاً أن يعلموا أنهم ما داموا في هذا العالم، فإنهم يستطيعون جبران ما
خسروا وما ضيّعوا، وان يكفّروا عن معاصيهم، فإن الأمر سيخرج من أيديهم بمجرد
انتقالهم من هذا العالم، والتعويل على شفاعة أولياء الله(عليه السلام)، والتجرؤ في
ارتكاب المعاصي من الخدع الشيطانية الكبرى. وتأمّل أنت، يا من تعوّل على شفاعتهم
غافلاً عن الله ومتجرئاً على المعاصي، تأمّل في سيرتهم، وانظر في أنينهم وبكائهم
ودعائهم وتحرّقهم وذوبانهم أمام الله، واعتبر من ذلك.
يروى أن الصادق(عليه السلام) جمع أهل بيته في أواخر عمره وقال لهم: "إنكم ستردون
على الله بأعمالكم، فلا تظنوا أن قرابتكم لي ستنفعكم يوم القيامة". وان كان هناك
احتمال بأن تنالهم الشفاعة لأن الارتباط المعنوي حاصل بينهم وبين الشافع لهم،
فالرابطة الإلهية بينهم تجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لنيل الشفاعة، وإن لم يحصل هذا
الأمر لهم في هذا العالم، فلعله يحصل لهم بعد تنقيات وتزكيات وأنواع من العذاب
البرزخي أو الجهنمي، حتى يصبحوا بعده لائقين للشفاعة، والله العالم بحدود ما
سيصيبهم.
فضلاً عن هذا فإن الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول الشفاعة لا تبعث ـ بعد
التأمل فيها ـ الاطمئنان في الإنسان، قال تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه}.
وقال: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}. وأمثال ذلك من الآيات التي تثبت موضوع الشفاعة،
ولكنها في الوقت نفسه لا تبعث الاطمئنان لدى الإنسان ولا تسمح له بالاغترار بها؛
لأنها لم توضح من هم أولئك الذين ستكون الشفاعة من نصيبهم، أو ما هي شروطها، ومتى
تكون شاملة لهم.
نحن نأمل الشفاعة، ولكن ينبغي أن يدفعنا هذا الأمل نحو طاعة الحق تعالى، لا نحو
معصيته.
بنيّ:
أحرص على أن لا تغادر هذا العالم بحقوق الناس فما أصعب ذلك وما أقساه! واعلم ان
التعامل مع أرحم الراحمين أسهل بكثير من التعامل مع الناس. نعوذ بالله تعالى أنا
وأنت وجميع المؤمنين من التورط في الاعتداء على حقوق الآخرين، أو التعامل مع الناس
المتورطين.
ولا أقصد من هذا دفعك للتساهل بحقوق الله والتجرؤ على معاصيه، فلو اننا أخذنا بنظر
الاعتبار ما يستفاد من ظاهر بعض الآيات الكريمة، فإن البلية ستزداد باطّراد، ونجاة
أهل المعصية بالشفاعة يتم بعد المرور بمراحل طويلةٍ ومعقدة. فتجسم الأخلاق
والأعمال، وما يستتبع ذلك من ملازمتها للإنسان إلى ما بعد الموت وإلى القيامة
الكبرى، ثم إلى ما بعدها حتى الوصول إلى التنزيه وقطع الروابط بنزول الشدائد
والعذاب بمختلف أشكاله في البرازخ وفي جهنم، وعدم التمكن من الارتباط بالشفيع،
والاشتمال بالشفاعة؛ كلها أمور يؤدي التفكير فيها إلى إثقال كاهل الإنسان، ويدفع
المؤمنين نحو الجدية في الإصلاح، ولا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه يقطع بخلاف هذه
الاحتمالات، إلا إذا كان شيطان نفسه قد تسلط عليه بدرجة عالية، حتى راح يتلاعب به،
ويصده عن طريق الحق، فيجعله مُنكراً لا يفرق بين الضوء والظلام، وأمثال هؤلاء من
عمي القلوب كثير. حفظنا الله من شرور أنفسنا.
وصيتي إليك يا بني أن لا تدع الفرصة تضيع من يديك ـ لا سمح الله ـ وان تسعى في
إصلاح أخلاقك وتصرفاتك، إمّا بتحمل المشقة والترويض، وإمّا بالحدّ من تعلقك بالدنيا
الفانية، وتختار طريق الحق أينما اعترضك مفترق للطرق، وان تجتنب طريق الباطل، وتطرد
شيطان النفس عنك.
كذلك فإن من الأمور المهمة التي ينبغي أن أوصي بها: الحرص على إعانة عباد الله،
خصوصاً المحرومين والمستضعفين المظلومين، الذين لا ملاذ لهم في المجتمعات، فابذل ما
في وسعك في خدمتهم، فذلك خير زاد، وهو من أفضل الأعمال لدى الله تعالى، ومن أفضل
الخدمات التي تُقدم للإسلام العظيم. اسعَ في خدمة المظلومين، وفي حمايتهم في مقابل
المستكبرين الظلمة.
واعلم ان المشاركة في أمور السياسة والاجتماع الصحيحة، هي إحدى الوظائف المهمة في
عهد الحكومة الإسلامية، كذلك فإن مساعدة المسؤولين والمتصدين لإدارة أمور الجمهورية
الإسلامية ودعهم مسؤولية إسلامية وإنسانية ووطنية. أملي أن لا يغفل الشعب المجيد
والواعي عن هذه المسؤولية، وعليهم أن يواصلوا ـ وكما هو شأنهم حتى الآن، إذ كانوا
حاضرين في الساحة دوماً، حتى إن الحكومة الإسلامية والجمهورية ما استطاعت الاستقرار
والبقاء إلا بدعمهم ـ عليهم أن يواصلوا دورهم هذا في المستقبل أيضاً، وأني مفعم
بالأمل أن يواصل الجيل الحاضر والأجيال القادمة وقوفهم بوفاءٍ مع الجمهورية
الإسلامية ودعمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ليكونوا سبباً في ديمومتها
واستقرارها.
وعلينا جميعاً أن نعلم بأننا مادمنا على عهدنا مع الله تعالى، فإنه معنا، وكما
ساعدنا سبحانه وتعالى إلى الآن بالقضاء على مؤامرات المجرمين في الداخل والخارج
وبشكل إعجازي، فإنه سيقضي عليها مستقبلاً أيضاً بتأييداته إن شاء الله تعالى.
والأمل أن يكون أبناء جيشنا وحراس ثورتنا وأبناء قوات التعبئة الشعبية وسائر القوات
العسكرية والأمنية، وجماهير شعبنا قد تذوقوا حلاوة الاستقلال والخروج من أسر القوى
الدولية الكبرى الناهبة، وآمل أن يرجّحوا تحررهم من أسر الاجانب على أيّ شيء وعلى
أيّة حياة مرفهة، وان لا يقبلوا بتحمل عبء عار الارتباط بالقوى الشيطانية على
كواهلهم؛ وان يقبلوا بالموت المشرّف ـ برجوله واختيار ـ في سبيل الاهداف السامية
وفي سبيل الله؛ إذا أريدت لهم الحياة بذلةٍ؛ وان يختاروا السير على طريق الأنبياء
العظام وأولياء الله(عليه السلام). وأدعوا الله، خاضعاً معرباً عن عجزي، أن يزيد من
وعي وحب والتئام صفوف الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من أبناء شعبنا العزيز، وأن
يفيض عليهم برحمته، فيقفوا بثبات في طريق الله، وأن ينشروا الإسلام العزيز وأحكامه
النورانية في مختلف أنحاء العالم.
بنيّ:
لا يفوتني أن أكتب لك بضع جملات حول الأمور الشخصية لأختتم بها حديثي المطنب هذا:
أشدّ ما أود أن اوصيك به ولدي العزيز، هو الاهتمام بوالدتك الوفيّة.
إن الحقوق الكثيرة للأمهات أكثر من أن تحصى أو أن يؤدى حقها من الشكر، فليلة واحدة
تسهرها الأم مع وليدها تفوق سنوات من عمر الأب المتدين، فتجسّد العطف والرحمة في
عينيها النورانيتين بارقة من رحمة وعطف رب العالمين، فالله تبارك وتعالى قد اشبع
قلوب وأرواح الامهات بنور رحمة ربوبيته بشكل يعجز عن وصفه الواصفون، ويعجز عن
إدراكه سوى الأمّهات؛ وان رحمة الباري هي التي تجعلهن يقفن ويتحملن بثبات عجيب إزاء
المتاعب والآلام منذ استقرار النطف في الأرحام، وطوال فترة الحمل، وحتى ساعة
الولادة؛ ثم منذ عهد الطفولة، وحتى آخر العمر، وهي المتاعب والآلام التي عجز الآباء
عن تحمّلها ليلة واحدة.
فالتعبير الرقيق الوارد في الحديث الشريف "الجنة تحت أقدام الأمهات" حقيقة تشير إلى
عظم دور الأم، وتنبه الأبناء إلى ان السعادة والجنة تحت أقدام الأمهات؛ فعليهم ان
يبحثوا عن التراب المبارك لأقدامهن، ويعلموا أن حرمتهن تقارب حرمة الله تعالى، وان
رضا الباري جلّت عظمته إنما هو في رضاهن.
إن الأمهات ـ رغم أنهن جميعاً مثال لذلك ـ إلا أن بعضهن يتمتعن بخصائص أخرى تميزهن
عن الأخريات؛ وقد أدركت على مدى عمري، ومن الذكريات التي أحملها عن والدتك
المحترمة، وعن الليالي التي كانت تقضيها مع اطفالها، بل وحتى الأيام، انها تحمل مثل
هذه المزايا، لذا فاني أوصيكم يا ولدي ـ أنت وبقية أبنائي ـ بأن تجهدوا بعد وفاتي
في خدمتها، وتحرصوا على راحتها ونيل رضاها، وكما أراها راضية عنكم في حياتي، بل ان
تبذلوا مساعيكم أكثر في خدمتها بعد وفاتي.
وأوصيك يا ولدي أحمد: بأن تحرص على معاملة أرحامك وأقربائك وخصوصاً أخواتك وأبناء
إخوانك بالعطف والمحبة والصفاء والسلام والإيثار، وبمراعاة السلوك الحسن. كما أوصي
جميع أبنائي بأن يكونوا قلباً واحداً، وأن يتحركوا نحو هدفٍ واحدٍ، وأن يتعاملوا مع
بعضهم بالمحبة والعطف، وان يسعوا جميعاً للعمل في سبيل الله، وفي خدمة عباد
المحرومين، لأن في ذلك خير وعافية الدنيا والآخرة.
وأوصي نور عيني (حسين) أن لا يغفل عن الانكباب على تحصيل العلوم الشرعية،
وأن لا يبدد ما أنعم الله عليه من الاستعداد واللياقة سدى، وان يعامل والدته وأخته
بمنتهى العطف والصفاء، وان يستصغر الدنيا، ويسلك في شبابه طريق العبودية المستقيم.
وآخر وصيتي إلى أحمد: أن يحسن تربية أبنائه، وان يعرفهم ـ منذ نعومة أظفارهم ـ
الإسلام العزيز، وان يرعى أمّهم العطوفة، ويحرص على خدمة جميع أفراد العائلة
والأقارب.
وسلام الله على جميع الصالحين.
وأستميح جميع أقاربي عذراً ـ وبالأخص أبنائي ـ وأرجوا أن يعفوا عني إن كنت قصرت
معهم، أو ظهر مني قصور ما، أو أن كنت ظلمتهم، وأن يدعوا الله أن يغفر لي ويرحمني
إنه أرحم الراحيمن.
وأدعو الله متضرعاً إليه أن يوفق أرحامي وأقاربائي إلى طريق السعادة والاستقامة،
وأن يشملهم برحمته الواسعة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويقطع أيدي المستكبرين
والقوى الظالمة، ويكفّها عن الظلم.
والسلام والصلاة على رسول الله، خاتم النبيين، وعلى آله المعصومين، ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الأربعاء 4 رجب 1402هـ
روح الله الموسوي الخميني